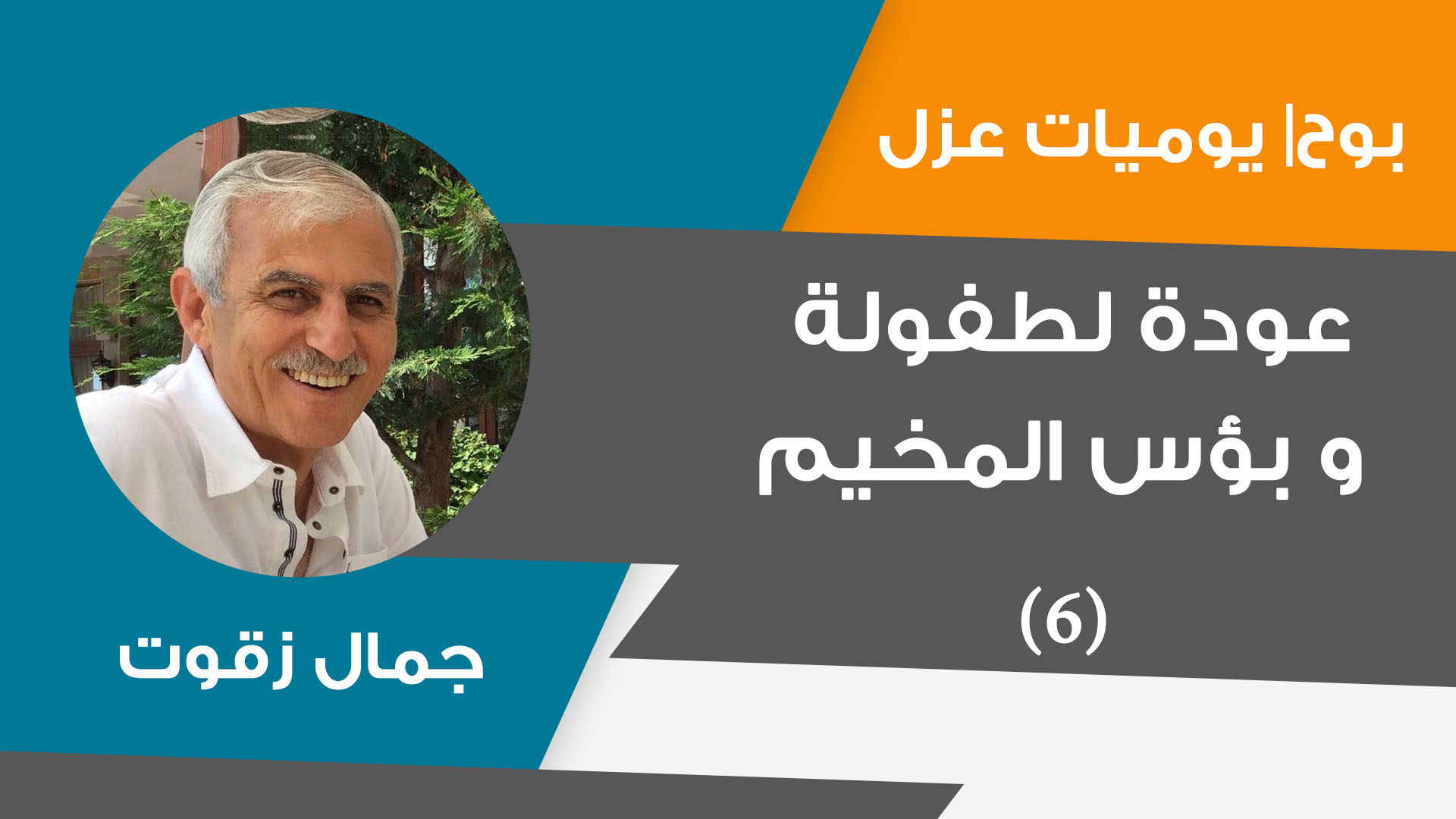الكاتب: جمال زقوت
بدأت الخلايا العسكرية للفدائيين تتسع و يزداد نشاطها، و بدأ الكثير من النشطاء البحث عن بقايا السلاح و تجميعه، أذكر في أحد الليالي حضر لبيتنا قاسم ناجي وهو صديق لأبي كان يعمل سائقاً في عيادة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” يحمل شوالات من البنادق، بقيت عندنا حتى قبل شروق الشمس، حيث حضر هو و آخرين لاستلامها.
و في عام 1970 نُفِّذَت عملية عسكرية بالقرب من الشجاعية قيل حينها أنها استهدفت عاملين من السفارة الامريكية، و على ما يبدو أن معلومات وصلت جيش الاحتلال بأن منفذي العملية من مخيم الشاطئ، أو كان ذلك مجرد ذريعة من أجل البدء بعملية تستهدف البدء بتدمير المخيم و تفريغه من السكان، ففرض الجيش منع تجول على المنطقة الغربية من مخيم الشاطئ و هي المنطقة الممتدة من قهوة غبن على طول الشارع الممتد شمالاً مروراً بجامع أبو يحيى ، و الذي كنا نسميه الجامع الأبيض و حتي نهاية المخيم الشمالي الذي بات يعرف لاحقاً بالمشتل، و عززت حصارها العسكري بالأسلاك الشائكة، و سمحت لمن يريد الخروج من هذا الحصار المفتوح على مصراعيه زمنياً ولكن غير مسموح له بالعودة باستثناء العاملين في الصحة او وكالة الغوث بإمكانهم أن يخرجوا صباحاً و يعودوا بعد العمل و كان والدي واحداً منهم ولكنه لم يعود كل يوم.
بدأت قوات الاحتلال حملة تنكيل واسعة النطاق في كل بيت و استهدفت كل الناس بصورة همجية ليس لها مثيل، فعندما تقتحم البيت تسجن كل أفراد العائلة في غرفة و تغلق الباب عليهم و تعيث فساداً في البيوت الفقيرة بحجة التفتيش، فتضع الزيت على الطحين على السكر و الكاز و كل ما يحتويه البيت من مواد تموينية على الأرض، و قد جرت عمليات سرقة واسعة لمدخرات سواء أموال أو ذهب من بعض العائلات التي كانت تدخر من أجل التعليم الجامعي لابنائها.
أذكر أن جنود الاحتلال دخلوا بيت عمي شحدة “أبو فوزي” الذي توفى قبل أيام رحمه الله عن عمر ناهز ال99 عاماً، و هو زوج خالتي فاطمة رحمها الله، و بعد أن وضعوهم جميعاً في غرفة واحدة وهي عائلة كبيرة جداً، و خربوا ما يستطيعون تخريبه، تركوا الراديو مفتوحاً على محطة عبرية، مما جعل بيت عمي يظنون أن الجيش ما زال في حوش أو قاع الدار، فاستمروا محجوزين لمدة يومين إلى أن دخلت والدتي على بيت أختها لتطمئن عليهم، فكسرت باب الغرفة و أنقذتهم من مأساة كادت أن تفتك بهم، حيث كانوا قد أمروا بالبقاء في الغرفة و أن من سيحاول الخروج سيطلق عليه النار، و لنا أن نتخيل أكثر من عشرة أشخاص في غرفة لا تتجاوز مساحتها تسعة أمتار مربعة دون ماء ولا مرحاض ولا طعام لأكثر من يومين!.
وفي اليوم التالي وكنت أظنه كان الأسبوع الثالث مما بات يعرف لاحقا بطوق الشهر، لاحظنا صباحاً من شقوق الباب أن الجنود يضعون علامة (X) بالأحمر على سطر طويل من البيوت يمتد من بيتنا و حتي جامع الشيخ موسى، و هذا يشمل فعلياً عشرات البيوت.
وبعد وقت قصير دخل الجنود و أبلغونا بأن معنا ساعة لإخراج ما نستطيع لأنهم قرروا هدم البيت، كان أخي منير في السجن و يحقق معه بتهمة الإنتماء لخلية عسكرية تابعة للجبهة الشعبية، فظنينا أن ذلك ربما يكون السبب وراء قرار هدم البيت، و لكنه لم يكن كذلك حيث تبين أن عشرات المنازل ستهدم على طول الشارع، كما كنا علمنا من المحامين أن منير لم يعترف بأي من التهم و مؤكد سيطلق سراحه لاحقاً.
إذن ما يجري هو خطة لتهديم بيوت المخيم و البدء بتفريغه من سكانه، و تبين لاحقاً أن الهدف كان مزدوجاً أولاً البدء ببناء شاطئ استيطاني عرف فيما بعد بشريط غوش قطيف الذهبي وكان مفترض أن يمتد من شمال القطاع مروراً بمخيم الشاطئ حتى جنوبه و هذا يعني محاولة هدم البيوت الموازية للبحر و هي خطة شارون الذي كان في حينه قائداً للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال و التي تشمل قطاع غزة و شمال سيناء، و الثاني شطب قضية اللاجئين وتوطينهم في بيوت خارج المخيمات.
بدأنا نحن الأطفال و والدتي رحمها الله في تجميع ملابسنا و دفاترنا و بعض ألعابنا البسيطة التي نحصل عليها من مساعدات الوكالة، و نسابق الزمن وحيدين لإنقاذ ما نستطيع و عيوننا مليئة بالدموع و المكان يمتلئ بصراخنا، فوالدي لم يكن قد عاد للبيت قبل يوم حيث مكث ليلته في عيادة المخيم، و لم يسمح لأي من أولاد عمي أو الجيران الذين لن تهدم بيوتهم بالخروج لمساعدتنا، فقط نحن سمير الذي كان عمره خمسة عشر عاماً و أنا ثم كمال و وليد و الهام وأنعام، كنا نتحرك ذهاباً و إياباً لإنقاذ ما نسطيع و يتحرك معنا بكاء و صراخ كلوحة سوريالية لن تشهدها سوى في أفلام الرعب.
أتت الساعة المحددة لبدء الهدم و بدأت أنياب الجرافة الصغيرة تنهش جدران البيت و كرميده الفقير و كل محتوياته ومعه كل ملامح الحياة و ذكريات الطفولة و بعض الصور التي كانت د. أريكسون السويدية قد أهدتنا إياها عندما صورت فيلم العائلة السعيدة، و التي باتت اليوم مجللة بالحزن و الدموع و التشرد من جديد، ظهراً عاد والدي ليجد ركام البيت و دموع أبنائه و زوجته المتكدسين في دار خالتي، و لا أعرف كيف تمكنا من النوم ربما فقط كان ذلك بعد أن خارت كل قوانا فنمنا فوق بعضنا.
أثناء تراجيديا هدم البيت و دموعنا تملئ المكان و صراخنا يعلو للسماء، أنا و رغم طفولتي لاحظت جندياً نأي بنفسه عن المشاركة بهذه الجريمة و تنحى جانباً و جلس على تنكة يبدو أنها كانت لمأكولات الجنود، و كان كما يبدو متأثراً من المشهد الذي ربما سمعه من أاجداده إبان ممارسات النازي الألماني ضد غيتوهات اليهود في أوروبا، كان صامتاً و لم ينبس ببنت شفه، والموضوعية تلزمني القول أنني شاهدت الدموع في عينيه، ولأول مرة في حياتي أستطيع وكطفل أن أرى الإنسان داخل الجندي العدو الذي يقوم زملائه برمينا في العراء، وذكريات طفولتنا تحت أنياب جرافتهم.
مرّت أيام، و فجأة امتلأ الشارع المهدوم بالمعدات التي سوت ركام البيوت بالأرض و رممت جدران البيوت الملاصقة، وقد بات من الصعب أن يدرك من لا يعرف البيوت الصغيرة و شوارع المخيم الضيقة أن يصدق أنه كان هناك بيوت تأوي عائلات لاجئة و آباء و أمهات يصارعون شظف الحياة من أجل رعاية وتعليم أطفالهم ليكون لهم مستقبل يعوضهم لحين العودة عن خير الأرض التي فقدوها.
أيام أخرى و قبل أن يكتمل شهر الطوق بيوم حضرت شخصيات سياسية و صحافيين و غيرهم من كبار الضباط يبدو في لجنة تقصي حقائق على الجريمة التي فضح أمرها كما يبدو من جنود الاحتياط كذلك الجندي الذي حاول ألا يكون شريكاً في الجريمة رغم صمته في الميدان عليها، ذلك بعد أن تمكنت بلدوزرات جيش الاحتلال من إخفاء آثارها على الأرض، و لكننا بقينا أحياء فنحن الشاهد على البيت الشهيد الذي ولدنا فيه، و لن تغيب من مخيلتنا ذكرياته بحلوها و مرها و مشاغباتنا ومآسيها، قدرة و ذاكرة الإنسان و خاصة الأطفال أكبر من كل سيرڤرات التكنولوجيا، و الملفت أنها تحول المأساة لذكرى تستحق الحفظ و الإعتزاز بها و ربما الفخر بتفاصيلها المحزنة…. يتبع


المصدر: جمال زقوت
تحرير: ولاء أبوبكر